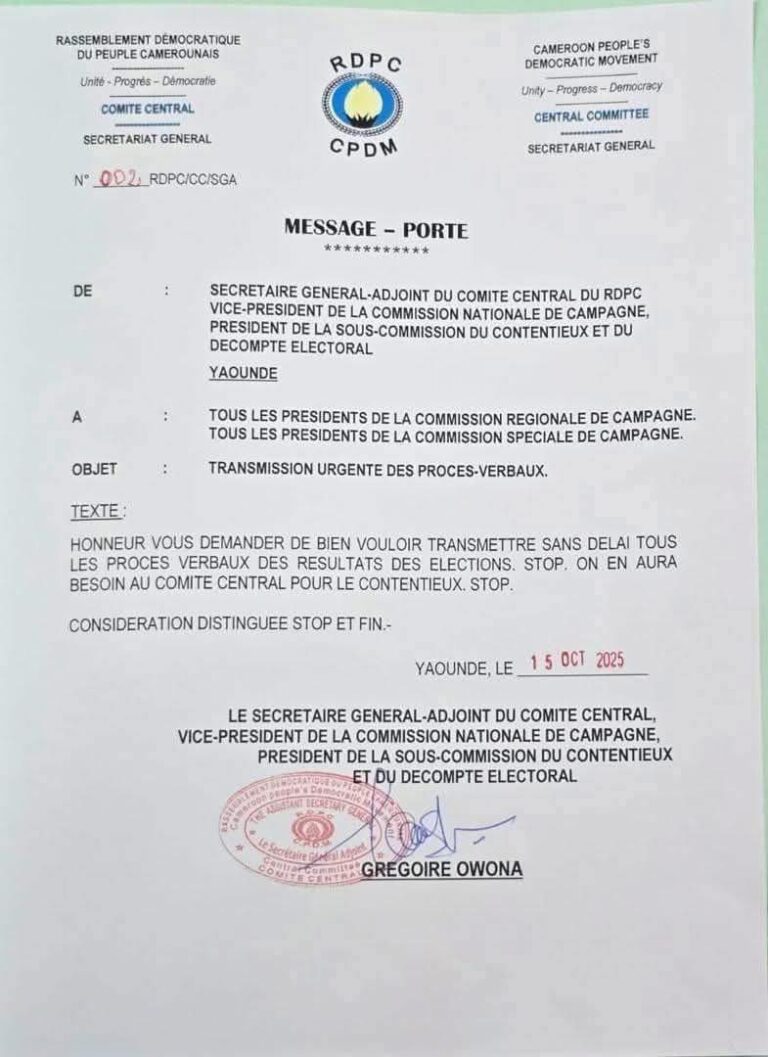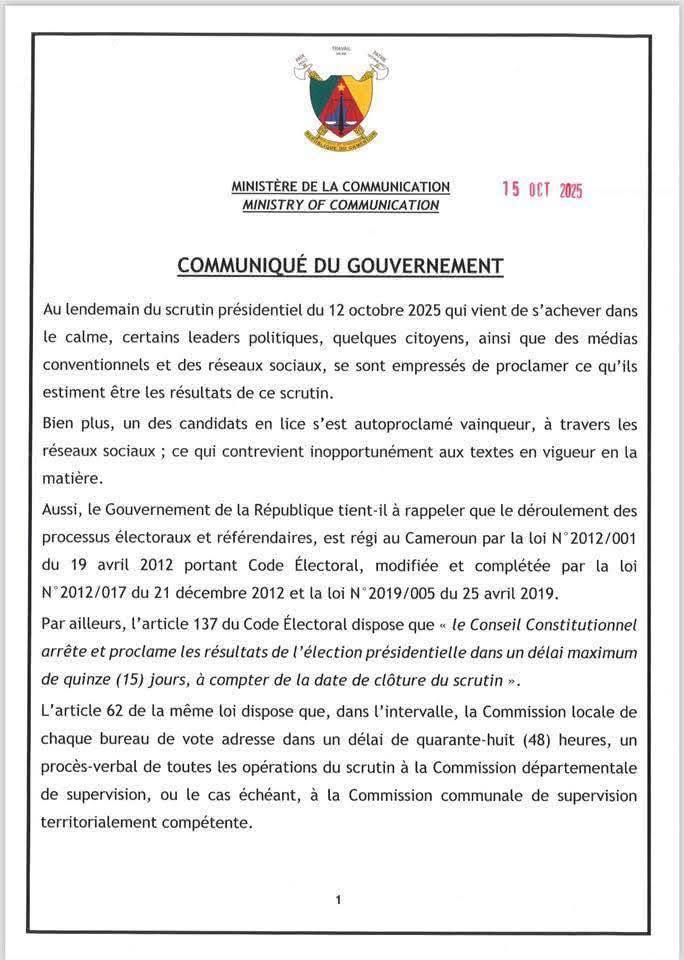✍????ياسر الفادني
(ما كنت عارف) ليست مجرد أغنية شغفٍ واعٍ بالندم، هي ضربٌ من الطرب الشعبي المدجّج بصدق الكلام وبساطة الانكسار، بدايةً النص الشعري الذي وقّعه محمد جعفر عثمان ينطلق من لغة قريبة من اللسان العام (يا ريت، كنت عارف…..، جاري وراء السراب) ! فتتبدّى لحظة المصارحة كقلبٍ نابضٍ في كل سطر، التكرار المتعمّد للعبارة ما كنت عارف ياريت ياريتني كنت عارف يعمل كقيدٍ عاطفي يُعيد المستمع إلى نفس عقدة الألم في كل مرة، ويحول النشيد إلى مُتنّ مؤلم يسهُل ترداده، الشاعر لا يلجأ إلى صورٍ معقّدة أو تجريدات فلسفية، يسير في خطٍ مباشرٍ من الأمل إلى الخيبة، من الثقة إلى الخداع، وما يجعل الكلام ناجحا هو توزانه بين العفوية العامية والصور البلاغية البسيطة (جاري وراء السراب) ، (مخدوع وضاع الزمن) صورٌ قادرة على استدعاء منظرٍ داخلي ملموس دون تفريط في الصدق الشعوري.
أما جماليات اللغة نلمس فيها إستعمالاً فعّالاً للتكرار والإعادة كآلية لبلورة الانفعال، التوازي الصوتي بين (ما كنت عارف) ويا ريت يخلق إيقاعاً لفظياً متكرّراً يسهُل على الأذن ويتحول إلى قلبٍ لحن الأغنية، أسلوب الشاعر يميل إلى المدرسة الرومانسية الشعبية: عاطفة مباشرة، مفردات يومية، وقوة في التعبير تقرب النص من المتلقي فلا يحتاج إلى شروحات ، كذلك يستثمر الشاعر الإشارات العاطفية التقليدية الندم، الحنق، الحنين لكنه يقدّمها بصيغةٍ تجعلك تشعر أن الموقف لم يُروَ من قبل، لأن الصياغة الدارجة تمنحها صدق اللحظة.
اللحن الذي وضعه عمر الشاعر يعمل كمرساةٍ عاطفية للنص، من الناحية الموسيقية يمكن وصفه بأنه يعتمد على وحدة لحنية مركزية، تُكرَّر وتُطوَّر، ما يمنح الأغنية هيكلة متماسكة: جملة لحنية بسيطة تُفتتح وترتفع عند يا ريت ثم تنكشف في انحدارٍ حزين في نهاية كل مقطع، هذا التصاعد والانخفاض اللحنى يواكب بذكاء منحنى العاطفة يتصاعد الأمل ثم ينهار الخذلان وهو أمر أساسي في صناعة أغنية تأسر القلب، تركيب اللحن يبدو قائماً على مقاماتٍ شرقية أو نصف مقاميّة تمنح النغمة ثنياتٍ وحنياتٍ تلامس حسّ الحنين لدى المستمع العربي، مع ترك مساحات للتزيين الصوتي (melisma) على حروف التمديد مثل «ياااااا ريت» و«وا حسرتي»، حيث توظف الزخارف الصوتية لتعميق الشعور.
الإيقاع والمرتبة الإيقاعية في العمل يعطيان الأغنية هواءها النفسي: إيقاع متوسّط السرعة يسمح للفنان بالتريث والتلوين، ويمنح الكلمات فرصة للتنفس والعمل الدرامي في الصوت، لا إيقاع مطرِّد سريع يكسر الجملة ولا بطءٍ يُغرق المقولة في تمطيط بلا طائل، من حيث الترتيب الصوتي عادةً ما تُبنى الفقرات على عزفٍ رقيق آلات وترية تتوسّطها طبقات إيقاع بلطف (طبلة، دف أو إيقاعات خفيفة) تتصاعد في الكورس لفتح مساحة احساسية أوسع، ثم تهبط لتعود للحن المركزي.
أمّا صوت عبد العزيز المبارك فهو العامل الذي يحوّل النص واللحن إلى تجربة حسّية مباشرة، صوته هنا يظهر طبقات واضحة: قاعدة صدرية تمنحه دفءً وعمقاً في الجمل المنخفضة، وقدرة على الصعود إلى دائرة وسطى فيها مزيج من الحِسّ والغَلّوة، مع تقنيات زخرفية في الأعلى قادرة على التقاط النبرة الانفعالية للبيت، جمال صوته ليس في صفاءٍ زئبقي بحت، بل في قوامه الخشن قليلاً والدافئ في آنٍ واحد تلك الخشونة تمنح الكلمات واقعية وتكسر أي تمثيل زائد، فتشعر أن الرجل يحكي قصته لا يؤدي دوراً مسرحيّاً، سيطرته على الطوارئ الصوتية وإحكامه لمدّ النفَس يخلقان لحظاتِ يقظة عاطفية: هبوط بسيط في آخر الجملة، جذبٌ ناعم على كلمة، ثم انفلات قصير في (يا ريت) كل ذلك يضع المستمع داخل رحم التجربة
إني من منصتي أستمع … ثم أحس بجاذبية للمستمع تنبع من تآزر ثلاثة: كلمات بسيطة وصادقة يستجيب لها أي قارئ لتجربة الحب والخداع، لحن مركزي واضح ومطوَّر يحفظ الذاكرة، وصوت يؤمّن صدقية الأداء. هذه الثلاثية تحقّق العدوى العاطفية، المستمع لا يتعب من التكرار بل يستسلم له، لأن كل تكرار يحفر معنى أعمق، من ناحية الأداء السينمائي الداخلي، الأغنية تشتغل كحوار داخلي الشاعر يتحدّث إلى نفسه، والمطرب يقرأه بصوتٍ مرهف.